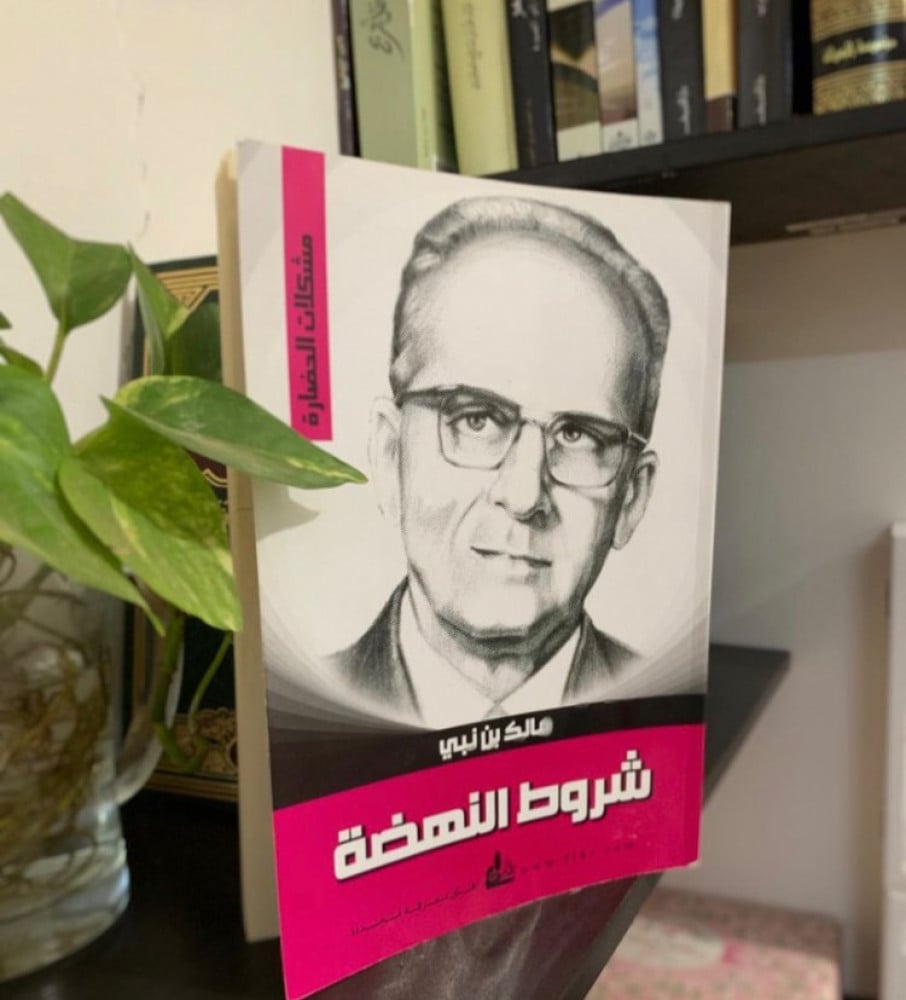يتأمل كثير من الكتاب المفكرين في الداء الفردي والجماعي للأمة، يمضي جُلّ الوقت في تأمل الداء.. إلاأن مالك بن نبي في كتابه كان يشرح الدواء (شروط الإصلاح والنهضة) وأهميته وأثاره وكيف نصل إليه. يقول في هذا السياق : " إن مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته، ولا يمكن لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضارات أو تهدمها" إذًا نحن نريد معرفة أساس الحضارة لا نتائجها المادية المتكدسة!
ولسان حاله يقول: ماذا يفيد تأمل المشاكل بلا تفكير بخطوات ولو كانت صغيرة إلى الحلول! ماذا يفيد أن نطالب بالحقوق والواجبات تنتظر أن ننجزها ونفكر فيها؟ ما الجدوى من مطالب إخراج الاستعمار من الأرض وهو متجذر فينا ومخلفاته مقيمة بيننا؟!
وكما يقول بن نبي: " لكيلا نكون مستعمرين يجب أن نتخلص من القابلية للاستعمار"
من هنا.. من هنا تتضح فكرة مالك بن نبي الإصلاحية في هذا الكتاب و جلّ كتبه.
" القابلية للاستعمار" والتخلص منه، والقاعدة الأصيلة التي يمشي في ظلها هي: « إن الله لا يُغير ما بقومٍ حتى يُغيروا ما بأنفسهم»
* إنها شرعة السماء: غير نفسك تغير التاريخ.
____________________
كتاب شروط النهضة هو الخطوط العريضة لمشكلات الحضارة ولأفكار مالك بن نبي، وتشخيص أزمة الحضارة الاسلامية واقتراح الحلول. لقد عاصر مالك بن نبي الحياة الغربية في باريس من الداخل معاينةً ودراسةً تطبيقية ونظرية.
والآن، دعونا نتحدث عن تقسيم الكتاب:
1- الماضي والحاضر = باب تشخيص المرض وما نحن فيه من تخلف والتراكمات التاريخية لذلك).
إن من العوائق التي تُعيقنا عن التقدم أننا ما زلنا نفكر بدور الأبطال ونقف على الأطلال.. ينبغي أن نفهم ونعي أن دور البطولة قد انتهى!
لا بد من أن نصرف أنفسنا إلى صناعة التاريخ الذي يتطلب عملًا ضمن سنن معينة ونظرة إلى المستقبل، لا البقاء في دوامة الماضي.
2- المستقبل:
( الأفكار الإصلاحية الأولى له)
* ناقش فيه أننا بتعاملنا مع الغرب نقوم بتكديس الأفكار كما نكدس الأشياء! - وهذا يذكرنا بتكديس الشهادات والمسمّيات-
* من أين نبدأ النهضة؟
لكي نعرف نقطة البداية لابد أن نُعرف الحضارة بادئ ذي بدء.. ولقد عرف مالك بن نبي الحضارة بأنها ثلاثية من المكونات المُجتمعة
( الإنسان+ التراب+ الوقت)
هذه العناصر عندما تجتمع لا تُشكل حضارة بشكل عفوي! بل الذي يحركها ويجعلها تنمو هي الفكرة الدينية، لأن كل الحضارات وُلدت في أحضان الأفكار الدينية والعقائد مهما كانت.
" تولد الحضارات حيث المعابد"
ثمَّ إن هذه الفكرة الدينية لا يجب أن تكون راكدة بل يجب أن تتبناها كتلة بشرية وسيطة تجعلها تتحرك وتدمج عناصر الإصلاح الثلاثية!
* لكي تتحرك هذه العناصر بشكل متوازن لا بد من حل مشكلة العنصر الأساسي فيها (الإنسان)
وإذا أردنا أن نُعيد فعالية الإنسان يجب أن نُعيد القيمة لما يُكونه ويملكه : ( المال - العمل- الأفكار)
اقترح المؤلف فكرة " التوجيه" لأننا نملك الثروة والأفكار والأيدي العاملة إلا أنها مكدسة لا تعرف أين تتجه ولا تجد من يوجهها!
وهكذا يصبح عندنا ( توجيه المال- توجيه العمل: لا أن تبقى أعمالًا عشوائية- توجيه الأفكار: المبدأ الأخلاقي، الفني الصناعي، الجمالي)
* إذًا الحضارة هي أن نحل مشكلة المكون الأساسي لها ( الإنسان) = حل مشكلة أفكاره (الثقافة سلوكًا وتربية) وعمله وماله ( تحويله من ثروة مكدسة إلى رأس مال متحرك مُنتج).
ولقد بدأ كل باب بأنشودة رمزية لها دلالات ومعاني واقعية..
هذه نظرة وصورة عامة للكتاب ولأهم أفكاره الجوهرية..
إذًا، لو أردنا أن نلخص مشاكل نهضتنا فإنها بما يلي:
1-القلب للأوضاع..انصياع للأوثان لا الأفكار.
2- استبدال وهمٍ بوهم.
3- النظر بجزئية للحضارة ( نظرة الأشياء الواحدة) وهذا يُسقط في التناقضات.
* إن الحديث عن المرض أو الشعور به لا يعني بداهة الدواء! إننا منذ زمن طويل نعالج الأعراض ولاندري ما هو المرض الأساسي!
لأن الحديث عن جدر المرض والتطرق لعلاجه يأخذ وقتًا طويلًا، إذن فمعالجة الأعراض أيسر وأسرع نوعًا ما مقارنةً بعلاج المرض، والمجتمع المتألم من الأعراض غالبًا لن يصبر هذه المدة ليجتث الجذور.. ويكمن الخطأ هنا، أن الإصلاح وأدواته لم تكن ( تهدئ وتُسكّن) الأعراض، بل اتجهت مباشرة لعلاجها وصب كل الجهد عليها…وهذا الأمر متكرر على جميع الأصعدة ( تبديد الجهود على الشكليات)
* مقياس الحضارة عند مالك بن نبي:
( الحضارة هي التي تلد منتجاتها) فلكي ننشئ حضارة ليس علينا أن نشتري كل منتجات الأخرى! ولاأن ( نصنع) حضارة من المنتجات!
وهو يسير هنا بمصطلحي ( التكديس والبناء) => نحن نريد أن نبني حضارة، إذًا يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون.. لا أن نكدس أشيائهم سيئها وجيدها!
* إن التفاؤل بحضارة التكديس أسهل من أن نحفر عميقًا لنضع أساسات وننزع أخرى.. إلا أن النتيجة فق النهاية هي ( القِلة) والقلة فقط.. والرضى بأي شيء.
* إن الحضارة = هيكل + فكرة
والحضارة الغربية ستمنحك الهيكل الخارجي والجسد لا الروح!
———
* خطوات في الطريق إلى الحل:
1- أن نحدد مكاننا من دورة التاريخ، لأنه يُسهل علينا أن نعرف عوامل النهضة والسقوط في حياتنا.
2- أن ندرس مشاكلنا في إطار دورة الزمان الإسلامية لا الفردية.
3- النظر إلى الأفق= الاتجاه إلى البناء لا التكديس، وفق عمل مترابط كلي لا جزئي.
* في هذا الكتاب وخلال حديثه الإصلاحي جعل المؤلف بلده الجزائر أُنموذجًا لتُرى الأخطاء المُتبعثرة في الأمة بشكل واضح و مُصغر.
المشاكل متشابهة لذا قواعد الإصلاح واحدة كذلك!
ومن هنا نذكر مشكلة أساسية وجوهرية : الوثنية.. الوثنية بمعناها الواسع، من حُمّى الدراويش إلى أصنام السياسيين المُزوقة
ومن أوراق الحروز والتمائم، إلى حروز أوراق الانتخابات.
( إلى صنم الجهل المركب = ومن الجهل ينشق التعالم، وهذا الأخير لوحده مشكلة أساسية تنخر فيجسد الأمة).
يقول هنا : " إذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه لا يغرس أفكارًا بل ينصب أصنامًا"
ويقول:" من سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم والعكس صحيح أحيانًا".
* كلمات أخيرة:
* الانحراف ليس له طرق مرسومة نظرية! بل هي خطوات خاطئة وعثرات في الدرب.
* مفتاح الحل في روح الأمة لا في مكان آخر.
* يهتم مالك بن نبي بتغيير النفس حتى تكون قوية من الداخل لا تنقاد خلف التغيرات الساذجة الخارجية.
" وليس ينجو شعب من الاستعمار وأجناده، إلا إذا نجت نفسه من أن تتسع لذل مستعمر، وتخلصت من تلك الروح التي تؤهله للاستعمار"
وأختم بما ختم به الكتاب : " إن من الواجب ألا توقفنا أخطاؤنا عن السير حثيثًا نحو الحضارة الأصيلة… وإنما لا يجوز لنا أن يظل سيرنا نحو الحضارة فوضويًا يستغلها الرجل الوحيد أو يضلله الشيء الوحيد، بل ليكن سيرنا علميًا عقليًا، حتى نرى أن الحضارة ليست أجزاء مبعثرة ملفقة ولا مظاهر خلابة وليست الشيء الوحيد، بل هي جوهر ينتظم جميع أشيائها وأفكارها وروحها ومظاهرها… وإن قضيتنا منو بذلك التركيب( الإنسان + التراب+ الوقت)..
وذلك بتخطيط ثقافة شاملة يحملها الغني والفقير، والجاهل والعالم،حتى يتم للأنفس استقرارها وانسجامها مع مجتمعها".
ليلى هاشم
تويتر: e7sas8l
انستقرام: laylooooosh